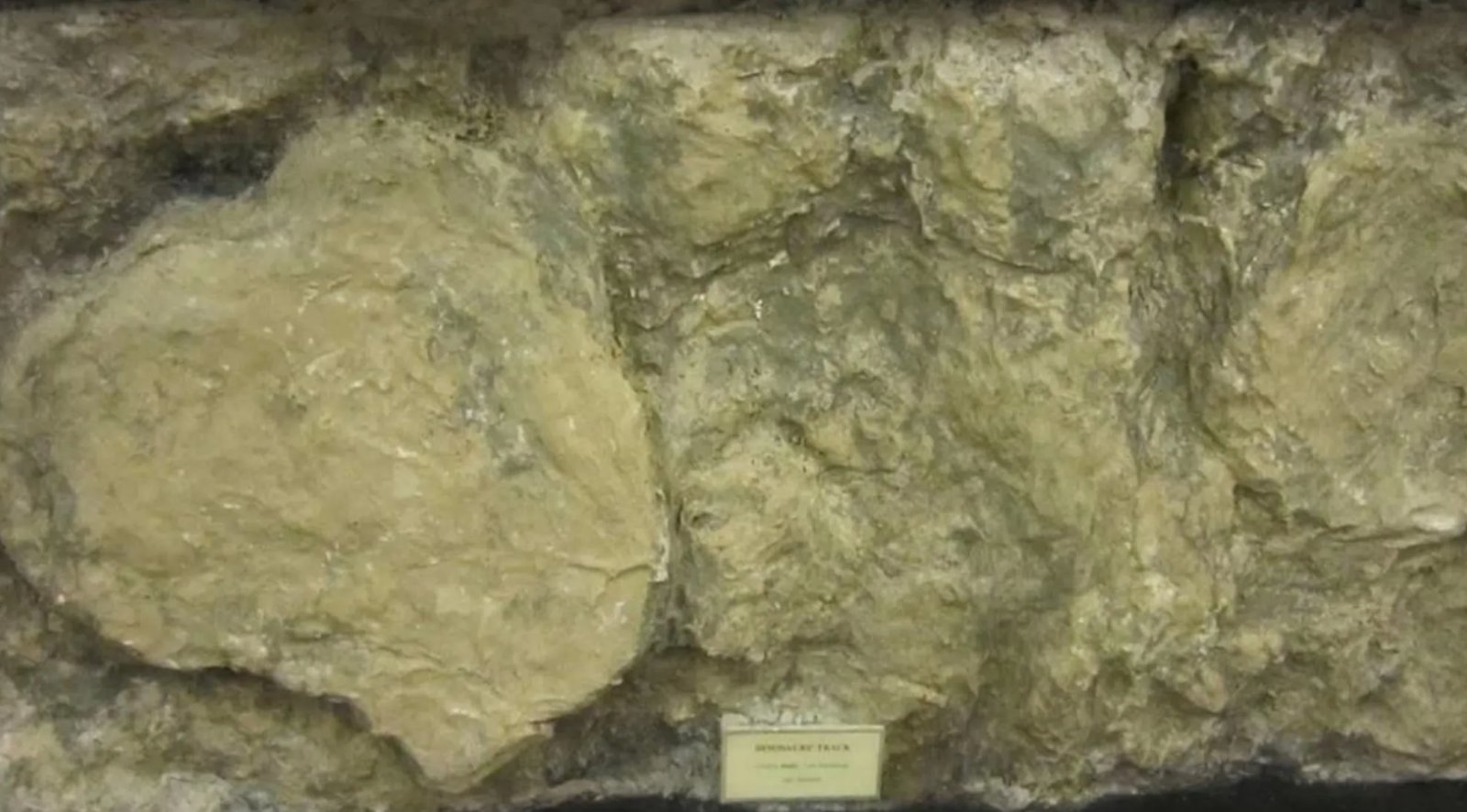يوما طيبا السيدات والسادة الأعزاء، أيها الأصدقاء الأعزاء!
يسعدني أن أرحب بكم جميعا في اجتماعنا التقليدي، وأشكركم على مشاركتكم في النقاشات الساخنة والهادفة التي يجريها منتدى”فالداي”.
نجتمع اليوم في السابع من نوفمبر، وهو تاريخ مهم في بلادنا، بل في العالم أجمع. ففي هذا اليوم قامت الثورة الروسية عام 1917، وهي ثورة، شأنها في ذلك شأن الثورات الهولندية والإنجليزية والفرنسية الكبرى في عصرها، كانت إحدى العلامات البارزة في تطور البشرية، والتي حددت بشكل كبير مسار التاريخ وطبيعة السياسة والدبلوماسية والاقتصاد والسياسة والنظام الاجتماعي.
وقد قدر لنا ولكم أن نعيش نحن أيضا في عصر من عصور التغييرات الجذرية والثورية من حيث الجوهر، ليس فقط من أجل أن نفهم، بل كي نكون مشاركين مباشرين في إحدى أعقد العمليات في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين، فيما يبلغ عمر منتدى”فالداي” بالتوازي العقد الثاني، نفس عمر قرننا تقريبا. في مثل هذه الحالات غالبا ما يقولون بالمناسبة أن الوقت يمر بسرعة دون أن يلاحظه أحد، إلا أننا في هذه الحالة لا نستطيع أن نقول ذلك. فلم يكن هذان العقدان مليئين فقط بالأحداث الأكثر أهمية، وأحيانا الدرامية ذات البعد التاريخي الحقيقي، بل إنه، وأمام أعيننا، يتم تشكيل نظام عالمي جديد تماما، عكس كل ما كنا نعرفه عن الماضي، مثل نظامي ويستفاليا أو يالطا على سبيل المثال.
فالقوى الجديدة آخذة في الصعود، وأصبحت الشعوب أكثر وعيا بمصالحها وقيمها الذاتية وأصالتها وهويتها، بينما يتزايد إصرارها على تحقيق أهداف التنمية والعدالة. في الوقت نفسه، تواجه المجتمعات عددا متزايدا من التحديات الجديدة: من التغيرات التكنولوجية المثيرة إلى الكوارث الطبيعية المأساوية، ومن التقسيم الطبقي الاجتماعي الصارخ إلى مواجهات الهجرة الضخمة والأزمات الاقتصادية الحادة.
ويتحدث الخبراء عن تهديدات الصراعات الإقليمية الجديدة، والأوبئة العالمية، والقضايا الأخلاقية المعقدة والغامضة في مجال التفاعل بين البشر والذكاء الاصطناعي، وكيفية المزج بين التقاليد الأصيلة والتقدم المتسارع.
وقد توقعنا بعضا من هذه المشكلات عندما التقينا سابقا، بل إننا ناقشناها بالتفصيل عندما التقينا هنا في “فالداي”، وبعضها كان حدسنا سبيلا لتوقعها، على أمل أن تفضي نحو الأفضل، لكننا لم نستبعد السيناريوهات الأسوأ.
وبعكس كل ذلك، وما أصبح مفاجأة تامة للجميع، جاءت الديناميكيات أقوى كثيرا مما نتوقع، وأصبح من المؤكد أننا عاجزون عن التنبؤ بالعالم الحديث. وإذا نظرنا إلى العشرين عاما الماضية، وتقييم حجم التغيير، وتوقع هذه التغييرات في السنوات المقبلة، فإن هذا يشير إلى السنوات العشرين المقبلة ستكون بنفس القدر من التحدي، إن لم تكن أكثر صعوبة، وهو أمر يعتمد على كثير من العوامل، وها هنا نحن اليوم في منتدى”فالداي” تحديدا من أجل تحليلها ومحاولة التنبؤ بشيء ما بقدر ما نحوز الآن من فهم.
الصراع اليوم صراع على المبادئ لا على السلطة و النفوذ
إن لحظة الحقيقة، بمعنى ما، قادمة لا محالة. قد يقول المرء إن الهيكل القديم للعالم قد اختفى إلى غير رجعة، وأن صراعا جديا لا يمكن تجنبه يتكشف من أجل تشكيل هيكل جديد، إلا أن هذا الصراع، أولا وقبل كل شيء، ليس صراعا على السلطة أو النفوذ الجيوسياسي، وإنما هو صراع على المبادئ ذاتها، المبادئ التي ستبنى عليها العلاقات بين الدول والشعوب في المرحلة التاريخية القادمة. وهو الصراع، الذي ستحدد نتائجه ما إذا كان بوسعنا جميعا أن نعمل سويا من خلال الجهود المشتركة، لبناء عالم يسمح للجميع بتنمية وحل التناقضات الناشئة على أساس الاحترام المتبادل للثقافات والحضارات، دون إكراه أو استخدام للقوة. وأخيرا يطرح هذا الصراع سؤالا بشأن ما إذا كان بإمكان المجتمع الإنساني أن يظل مجتمعا بمبادئه الأخلاقية الإنساني، وهل يبقى الإنسان إنسانا؟
وقد يبدو للوهلة الأولى أنه لا بديل لذلك، إلا أنه، ومع الأسف الشديد يوجد هذا البديل: أن تغرق الإنسانية في هاوية الفوضى العدوانية، والانقسامات الداخلية والخارجية، وفقدان القيم التقليدية، وأشكال جديدة من الاستبداد، والرفض الفعلي للمبادئ الكلاسيكية للديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية. ويتم تفسير الديمقراطية، على نحو متزايد، بأنها سلطة لا الأغلبية، وإنما الأقلية. بل إنهم يقارنون بين الديمقراطية التقليدية والديمقراطية مع بعض الحريات المجردة، التي من أجلها يمكن إهمال والتغاضي عن والتضحية ببعض الإجراءات الديمقراطية والانتخابات ورأي الأغلبية وحرية التعبير وذات الديمقراطية.
إن التهديد هنا هو الإملاء، والتحول إلى قاعدة الأيديولوجيات الشمولية في الأساس، وهو ما نراه في مثال الليبرالية الغربية، التي انحطت اليوم، فيما أعتقد، نحو التعصب الشديد والعدوان تجاه أي بديل آخر، وتجاه أي دولة ذات سيادة وقوة واستقلال فكري، وهو ما يقف اليوم مبررا للنازية الجديدة والإرهاب والعنصرية وحتى الإبادة الجماعية للمدنيين.
وأخيرا، فإن هذه صراعات واشتباكات دولية محفوفة بالتدمير المتبادل، وأضحت الأسلحة القادرة على القيام بذلك، في نهاية المطاف، موجودة ويتم تطويرها باستمرار، وتتخذ أشكالا جديدة مع تطور التكنولوجيا. وأصبح منتدى أصحاب هذه الأسلحة آخذ في التوسع، ولم يعد أحد يضمن عدم استخدامها في حالة تزايد التهديدات الشبيهة بالانهيار الجليدي والتدمير النهائي للمعايير القانونية والأخلاقية.
وقد قلنا بالفعل سابق أننا وصلنا إلى نقطة خطيرة، والدعوات الصادرة عن الغرب لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، الدولة التي تمتلك أكبر ترسانة من الأسلحة النووية، تكشف عن نزعة مغامرة شديدة لدى الساسة الغربيين. حسنا، لنقل البعض منهم على أي حال. إنها مثل هذا الإيمان الأعمى بإفلاتهم من المحاسبة والعقاب، وإحساسهم بالتفوق والاستثنائية والذي يمكن أن يتحول إلى مأساة عالمية. في الوقت نفسه، فإن القوى المهيمنة السابقة، التي اعتادت، من حقبة الاستعمار، على حكم العالم، تفاجأ بشكل متزايد حينما تجد أنها لا تطاع. ومحاولات التشبث بالسلطة والمراوغة بالقوة لا تؤدي سوى إلى عدم الاستقرار بشكل عام وزيادة التوترات والضحايا والدمار، بينما لا تسفر هذه المحاولات عن النتيجة التي يسعى إلها من يريدون الحفاظ على سلطتهم المطلقة غير المقسمة، فمسار التاريخ حتمي يستحيل أن يتوقف.
وبدلا من إدراك عدم جدوى تطلعات هؤلاء والطبيعة الموضوعية للتغييرات، يبدو أن بعض النخب الغربية على استعداد لفعل أي شيء لمنع ظهور نظام دولي جديد يلبي مصالح الأغلبية العالمية. وفي سياسة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في السنوات الأخيرة، على سبيل المثال، أصبحت مبادئ مثل “ألا ينتهي الأمر إلى من سوانا”، و”من ليس معنا فهو ضدنا” ملحوظة على نحو متزايد. حسنا، لأنه هنا، وفي أماكن متعددة من بلدان العالم هناك مقولة أن ما تزرعه ستحصده.
والفوضى وأزمة النظم تتزايد بالفعل في ذات البلدان التي تحاول اتباع مثل هذه السياسات، كما أن ادعاءاتها بالحصرية والاستثنائية، والتبشيرية الليبرالية العولمية، والاحتكار الأيديولوجي والعسكري السياسي، تستنزف بشكل متزايد تلك البلدان التي تحاول اتباع هذا النهج. ومثل هذه السياسات، التي تدفع العالم نحو التدهور، تتعارض بشكل واضح مع المصالح الحقيقية لشعوب الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية نفسها.
وأنا على يقين من أن الغرب سوف يفهم ذلك عاجلا أم آجلا. فقد كان أساس الإنجازات الغربية العظيمة الماضية دائما، وعلى وجه التحديد، النهج العملي والرصين، القائم على تقييم صارم للغاية، ساخر في بعض الأحيان، لكنه عقلاني يرصد ويحلل ما يحدث ويدرك إمكانياته الذاتية.
وفي هذا الصدد، أود التأكيد مرة أخرى على أن روسيا، بعكس خصومنا، لا ترى الحضارة الغربية عدوا، ولا تطرح سؤال “نحن أم هم”، أو “من ليس معنا فهو ضدنا”، نحن لا نقول ذلك أبدا. ونحن لا نريد أن نعلّم أي أحد أي شيء، أو نفرض نظرتنا للعالم على أي أحد. موقفنا منفتح وهو على النحو التالي:
لقد جمع الغرب موارد بشرية وفكرية وثقافية ومادية هائلة حقا، وبفضلها يمكنه أن يتطور بنجاح، ويظل أحد أهم عناصر النظام العالمي. لكنه وعلى وجه التحديد “أحد تلك العناصر” إلى جانب الدول ومجموعات الدول النامية الأخرى. ولا يمكن الحديث في البيئة الدولية الجديدة عن أي هيمنة. وعندما يفهمون ويعترفون بهذه الحقيقة التي لا يمكن دحضها أو تغييرها، في واشنطن وغيرها من العواصم الغربية الأخرى، فإن عملية بناء النظام العالمي الذي يلبي تحديات المستقبل سوف تدخل أخيرا مرحلة البناء الحقيقي. وآمل أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن، لأنه يصب في المصلحة المشتركة، بما في ذلك مصلحة الغرب نفسه في المقام الأول.
وفي غضون ذلك، يتعين علينا، نحن المهتمين بخلق عالم عادل ودائم، ان ننفق الكثير من الطاقة والجهد للتغلب على الأعمال التدميرية التي يقوم بها خصومنا، ممن لا زالوا يتشبثون باحتكارهم. إنه أمر واضح يراه الجميع في الغرب نفسه، وفي الشرق، وفي الجنوب، واضح في كل مكان. يحاولون الحفاظ على السلطة والاحتكار، وهي أمور واضحة.
كان من الممكن أن توجه هذه الجهود بشكل أكثر فائدة لمعالجة المشكلات المشتركة حقا التي تؤثر على الجميع: من التركيبة السكانية والتفاوت الاجتماعي إلى تغير المناخ، والأمن الغذائي، والطب، والتكنولوجيات الجديدة. إنه ما نحتاج جميعا إلى التفكير فيه، وما يحتاج الجميع حقا إلى العمل عليه والقيام به.
ولتسمحوا لي بتقديم بعض الاستطرادات الفلسفية اليوم، فمنتدى”فالداي” مخصص للمناقشة، لذا آمل أن يكون ما أقوله متماشيا مع المناقشات التي جرت هنا حتى الآن.
لقد أسلفت أن العالم يتغير على نحو جذري، ولا رجعة في تحوله. وهو يختلف عن أي نسخ أخرى لبنية النظام العالمي من خلال الجمع والوجود المتوازي لظاهرتين متنافيتين على ما يبدو: الصراع المتنامي بسرعة، وتجزئة المجال السياسي والاقتصادي والقانوني من ناحية، والترابط الوثيق المستمر بين العالم أجمع من ناحية أخرى. قد ينظر إلى هذا بوصفه نوعا من التناقض. فنحن معتادون في نهاية المطاف على حقيقة أن المسارات المحددة عادة ما تتبع بعضها البعض، وتحل محل بعضها البعض. وقرنا بعد قرن، تتناوب فترات الصراع وانهيار العلاقات مع فترات أكثر ملاءمة من التفاعل، وتلك ديناميكيات التطور التاريخي.
يتضح لنا أن ذلك لم يعد يعمل اليوم. دعونا نحاول التبحر قليلا في هذا الشأن: إن الصراعات الحادة والأساسية التي تحمل عواطف جياشة، تشكل بطبيعة الحال تعقيدا للتنمية العالمية، لكنها لا تقاطعها. فبدلا من سلاسل التفاعل التي دمرتها القرارات السياسية وحتى الوسائل العسكرية، تظهر سلاسل أخرى. نعم، إن الأمر أكثر تعقيدا ومربكا في بعض الأحيان، إلا أنه يحافظ على الروابط الاقتصادية والاجتماعية.
وقد رأينا من خبرة السنوات الأخيرة كيف قام ما يسمى بالغرب الجماعي بمحاولة غير مسبوقة لإبعاد روسيا عن النظام العالمي اقتصاديا وسياسيا، حيث أصبح حجم العقوبات والتدابير العقابية المطبقة ضد بلادنا لا مثيل له في التاريخ. وافترض خصومنا أنهم بذلك سيوجهون لروسيا ضربة قاضية ساحقة، لن تتعافى منها البلاد ببساطة، وستجبرها أن تكون أحد العناصر الأساسية للحياة الدولية.
وأعتقد أنه لا حاجة هنا للتذكير بما حدث على أرض الواقع. وتبدو لي حقيقة أن الذكرى السنوية التي جمع فيها منتدى”فالداي” هذا الحشد التمثيلي تتحدث عن نفسها. إلا أن النقطة بالطبع ليست في “فالداي”، وإنما النقطة الهامة هي الحقائق التي نعيش فيها والتي توجد روسيا في وسطها. فالعالم يحتاج إلى روسيا، ولا يمكن لأي قرارات تتخذها واشنطن أو بروكسل، اللتان تفترضان أنهما فوق الجميع، أن تغيّر من هذا الوضع.
والأمر نفسه ينطبق على الحلول الأخرى. فحتى السبّاح المتمرس لا يستطيع السباحة ضد تيار قوي، مهما كانت الحيل، وحتى المنشطات التي يستخدمها. وتيار السياسة العالمية، التيار السائد، يتجه في الاتجاه الآخر، المعاكس لتطلعات الغرب، من أفول عالم الهيمنة وصعود عالم التنوع. وهو أمر واضح، وكما يقول أهلنا: لا حاجة للذهاب إلى عرافة. هو أمر جليّ.
دعونا نعود إلى جدلية التاريخ، والعصور المتغيرة للصراع والتعاون. فهل أصبح العالم حقا بحيث لم تعد هذه النظرية وهذه الممارسة صالحة؟ دعونا نحاول أن ننظر إلى ما يحدث من زاوية مختلفة قليلا: ما هو هذا الصراع بالضبط، ومن يشارك فيه اليوم؟
منذ منتصف القرن الماضي، عندما تمكنت الجهود الحديثة، على حساب خسائر فادحة، من هزيمة النازية، الأيديولوجية الأكثر خبثا وعدوانية والتي أصبحت نتاجا لأشد التناقضات حدة في النصف الأول من القرن العشرين، كانت الإنسانية تواجه مهمة تجنب إحياء مثل هذه الظاهرة، وتكرار الحروب العالمية. وبرغم كل التعرجات والمناوشات المحلية، تم تحديد المسار العام بعد ذلك. كان ذلك بمثابة رفض جذري لجميع أشكال العنصرية، وتدمير النظام الاستعماري الكلاسيكي، وتوسيع عدد المشاركين الكاملين في السياسة الدولية، وكان الطلب على الانفتاح والديمقراطية في النظام الدولي صريحا وواضحا، ويعني التطور السريع لمختلف البلدان والمناطق، وظهور مناهج تكنولوجية واجتماعية واقتصادية جديدة تهدف إلى توسيع فرص التنمية وتحسين فرص الرفاهية. وبطبيعة الحال، وشأنها في ذلك شأن أي عملية تاريخية، أدى ذلك إلى تضارب في المصالح. ولكنني أكرر أن الرغبة العامة في المواءمة والتطوير في كافة جوانب هذا المفهوم كانت واضحة.
وقد ساهمت بلادنا، الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت، مساهمة كبيرة في تعزيز هذه التوجهات، فقد ساعد الاتحاد السوفيتي الدول التي حررت نفسها من التبعية الاستعمارية أو الاستعمارية الجديدة، سواء كانت في إفريقيا أو جنوب شرق آسيا أو الشرق الأوسط أو أمريكا اللاتينية. واسمحوا لي أن أذكركم بشكل منفصل أن الاتحاد السوفيتي، منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، هو الذي بادر بإنهاء المواجهة الأيديولوجية، والتخلص من إرث الحرب الباردة، أو أنه في الواقع قام نفسه بإنهاء الحرب الباردة، والتغلب على إرثها، وتحطيم الحواجز التي طالما حالت دون وحدة العالم وتنميته الشاملة.
نعم، لدينا علاقة معقدة مع تلك الفترة، بالنظر إلى ما انتهى إليه مسار القيادة السياسية للبلاد آنذاك. لكن، علينا أن نتعامل مع بعض العواقب المأساوية، ولا زلنا نكافح بشأنها. لكن الدافع نفسه هو ما وددت التأكيد عليه، كان الدافع مثاليا على نحو غير مبرر من جانب قادتنا وشعبنا، وأحيانا كان منشأ النهج الساذج، كما أصبحنا نراه اليوم، الرغبات الصادقة في السلام والأمن، كان الدافع هو الصالح العام، الذي هو في واقع الأمر أمر متأصل تاريخيا في شخصية شعبنا وتقاليده ونظامه القيمي وإحداثياته الروحية والأخلاقية.
فلماذا إذن أدت هذه التطلعات إلى نتائج عكسية؟ يطرح السؤال نفسه. نحن نعرف الإجابة، وقد سبق وذكرت ذلك أكثر من مرة بشكل أو بآخر. لأن الطرف المقابل من المواجهة الأيديولوجية لم ينظر إلى الأحداث التاريخية حينها بوصفها فرصة لإعادة بناء العالم على مبادئ وقوانين جديدة وعادلة، بل اعتبرها فوزا وانتصارا له، واستسلام لبلادنا أمام الغرب، بالتالي اعتبر ذلك نصرا مبينا. اعتبرها فرصة، ومن حق الفائز أن يبسط هيمنته الكاملة.
تحدثت عن هذا الأمر مرة واحدة، ولكن بشكل عابر، ولن أذكر أسماء. في منتصف التسعينيات، ربما نهايتها، قال أحد الشخصيات السياسية الأمريكية آنذاك: الآن سنتعامل مع روسيا لا كعدو مهزوم، ولكن كأداة جامدة عاطلة في أيدينا. وهذا ما استرشدوا به، ولم يكن هناك اتساع كاف في الرؤية، لا ثقافة عامة، ولا ثقافة سياسية. كان هناك عدم فهم لما يحدث، وجهل مطبق بروسيا في الطريقة التي أساء بها الغرب تفسير ما اعتبره نتائج الحرب الباردة، وفي الطريقة التي بدأ بها إعادة تشكيل العالم لنفسه، وفي جشعه الجيوسياسي المخزي وغير المسبوق. تلك هي المصادر الحقيقية لصراع العصر التاريخي الراهن، بدءا من مآسي يوغوسلافيا ومرورا بالعراق وليبيا وانتهاء بأوكرانيا والشرق الأوسط.
لقد بدا لبعض النخب الغربية أن الاحتكار الناشئ ولحظة الأحادية القطبية بالمعنى الأيديولوجي والاقتصادي والسياسي وحتى العسكري الاستراتيجي جزئيا، هي بيت القصيد، هي كل شيء، وقد وصلنا. “توقفي أيتها اللحظة، كم أنت رائعة!”، تم الإعلان عن ذلك حينها بغطرسة بوصفها تقريبا نهاية التاريخ.
ولا أظن أنني بحاجة لهذا الجمهور المجتمع هنا مدى قصر نظر هذه الرواية وضلالها. إلا أن التاريخ لم ينته عند هذه النقطة، بل على العكس من ذلك، فقد دخل إلى مرحلة جديدة. والنقطة لم تكن في أن بعض أعداء الغرب من الخبثاء والمنافسين والعناصر التخريبية منعوه من إنشاء سلطته العالمية المهيمنة.
ولنكن صادقين، فقد اعتقد كثيرون في هذا العالم في البداية أنه، وبعد اختفاء الاتحاد السوفيتي، نموذج البديل الاشتراكي السوفيتي، فقد جاء نظام الاحتكار لفترة طويلة، ربما إلى الأبد، وكانت الحاجة فقط للتكيف معه. إلا أن هذا النظام ترنح من تلقاء نفسه، تحت وطأة طموحات وجشع هذه النخب الغربية، وعندما رأوا أنه في إطار النظام الذي أنشأوه لأنفسهم (بعد الحرب العالمية الثانية، يجب الاعتراف أن المنتصرين أنشأوا نظام يالطا لأنفسهم، ثم بعد الحرب الباردة، بدأ المنتصرون المفترضون أيضا في تعديل نظام يالطا، وهنا كانت المشكلة)، حينما رأوا أن أشخاصا أخرى في إطار نفس هذا النظام يصلون إلى النجاح والقيادة، بالطبع بدأوا في انتهاك نفس القواعد التي كانوا يتحدثون عنها في الأمس القريب، وبدأوا في تغيير القواعد التي كانوا هم أنفسهم قد فرضوها.
فما هو نوع الصراع الذي نشهده اليوم؟ لدي قناعة أنه ليس صراعا بين الجميع وبعضهم، والناجم عن انحراف بعض القواعد التي كثيرا ما يحاول بيعها لنا الغرب، كلا على الأطلاق، ليس هذا. إنما نرى صراعا بين الغالبية العظمى من سكان الكوكب، التي تريد العيش والتطور في عالم مترابط مليء بعدد هائل من الفرص، والأقلية العالمية، التي لا يهمها سوى شيء واحد فقط، وكما قلت سابق، الحفاظ على هيمنتها. ومن أجل هذا، فهي على استعداد لتدمير الإنجازات التي نتجت عن التنمية الطويلة الأجل نحو نظام عالمي شامل. ولكن، وكما نرى، فلا طائل يأتي أو سيأتي من وراء ذلك.
في الوقت نفسه، يحاول الغرب نفسه نفاقا إقناعنا جميعا بأن ما حققته البشرية بعد الحرب العالمية الثانية أصبح مهددا. ولا شيء من هذا القبيل صحيح، فقد ذكرت للتو، ان روسيا والأغلبية العظمى من الدول تسعى جاهدة على وجه التحديد إلى تعزيز روح التقدم الدولي والرغبة في السلام الدائم، الذي كان جوهر التنمية منذ منتصف القرن الماضي.
ولكن، ما يقع تحت التهديد في واقع الأمر هو الاحتكار الغربي، الذي نشأ بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، والذي حصل عليه الغرب لبعض الوقت في نهاية القرن العشرين. وأريد القول هنا مرة أخرى، والحاضرون في هذه القاعة يدركون أن أي احتكار، وكما يعلمنا التاريخ، سينتهي عاجلا أم آجلا، ولا يمكن أن يكون هناك أي أوهام بهذا الصدد، والاحتكار هو دائما شيء ضار، حتى بالنسبة للمحتكرين أنفسهم.
إن السياسة التي تنتهجها نخب الغرب الجماعي مؤثرة، لكنها، واستنادا إلى عدد المشاركين في ناد محدود للغاية، لا تمضي قدما إلى الأمام، إلى الإبداع، بل تجذب إلى الخلف، إلى الاحتفاظ بالهيمنة. ويعرف أي مشجع رياضي، ناهيك عن المحترفين، في كرة القدم والهوكي وأي لون من ألوان فنون الدفاع عن النفس: اللعب من أجل مجرد الصمود يؤدي دائما إلى الهزيمة.
وبالعودة إلى جدلية التاريخ، يمكننا القول إن الوجود الموازي للصراع والرغبة في الانسجام هو، بطبيعة الحال، أمر غير مستقر. ويجب حل تناقضات العصر عاجلا أم آجلا عن طريق الموائمة، والانتقال إلى نوعية مختلفة. وعند الدخول في هذه المرحلة الجديدة من التنمية، مرحلة إنشاء بنية عالمية جديدة، فمن المهم بالنسبة لنا جميعا ألا نكرر أخطاء نهاية القرن الماضي، عندما حاول الغرب، كما قلت من قبل، فرض إملاءاته على الجميع، وهو نموذج محفوف بصراعات جديدة.
لا ينبغي، في العالم الناشئ متعدد الأقطاب، أن تكون هناك بلدان وشعوب خاسرة. ولا ينبغي أن يشعر أي أحد بالحرمان أو الإذلال. عندها فقط سنتمكن من ضمان الظروف المناسبة طويلة الأجل للتنمية الشاملة والعادلة والآمنة. إن الرغبة في التعاون والتفاعل، بلا شك، هي التي تسيطر على المواقف الأكثر حدة وتتغلب عليها، ويمكننا القول بثقة أن هذا هو التيار الدولي السائد، المسار الرئيسي للأحداث. وبرغم أنه من الصعب التنبؤ بالمستقبل، في خضم التحولات التكتونية الناجمة عن التغيرات العميقة في النظام العالمي، إلا أن بإمكاننا، من خلال معرفتنا باتجاه مسار العالم نحو التغيير، من الهيمنة إلى عالم معقد من التعاون المتعدد الأطراف، أن نحدد بعض الخطوط العريضة للمستقبل على أقل تقدير.
بوتين يذكر بـ 6 مبادئ طرحها أمام “فالداي” العام الماضي كأسس العالم الجديد
في حديثي بمنتدى “فالداي” العام الماضي، سمحت لنفسي بطرح ستة مبادئ ينبغي لنا، في رأيي، أن تشكل الأساس للعلاقات في مرحلة تاريخية جديدة من التطور. ولم تؤد الأحداث والزمن الذي مر، في رأيي، سوى إلى تأكيد عدالة وصحة المقترحات المطروحة آنذاك، والتي سأحاول تطويرها.
- أولا، الانفتاح على التفاعل هو القيمة الأكثر أهمية بالنسبة للغالبية العظمى من البلدان والشعوب. ومحاولات إقامة حواجز مصطنعة معيبة ليس فقط لأنها تعيق التنمية الاقتصادية الطبيعية التي تعود بالنفع على الجميع، بل إن انقطاع العلاقات أمر خطير بشكل خاص في ظروف الكوارث الطبيعية والاضطرابات الاجتماعية والسياسية، التي للأسف لا يمكن تجنبها في الممارسة الدولية. من ذلك ما حدث على سبيل المثال العام الماضي بعد الزلزال الكارثي في آسيا الصغرى، ولأسباب سياسية بحتة، تم حظر وصول المساعدات الإنسانية للشعب السوري، فيما تعرضت بعض المناطق لأضرار بالغة بسبب الكارثة. ومثل ذلك أمثلة كثيرة، عندما تعيق المصالح الأنانية والانتهازية لتحقيق الصالح العام. إن البيئة الخالية من العوائق التي تحدثت عنها في العام الماضي هي المفتاح ليس فقط لتحقيق الرخاء الاقتصادي، بل وأيضا لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة. وفي مواجهة التحديات الجديدة، بما في ذلك عواقب التطور السريع للتكنولوجيا، من الضروري للبشرية أن توحد الجهود الفكرية. ومن الجدير بالملاحظة هنا أن المعارضين الرئيسيين للانفتاح اليوم، هم أولئك الذين رفعوه شعارا لهم بالأمس القريب.اليوم، تحاول نفس القوى والأشخاص استخدام القيود كأداة للضغط على المعارضين. ولن يتم تحقيق أي شيء من هذا لنفس السبب: فالأغلبية العالمية الضخمة تؤيد الانفتاح دون تسييس.
- ثانيا، تحدثنا دائما عن تنوع العالم كشرط أساسي لاستدامته. وربما قد يبدو الأمر كمفارقة، لأنه كلما زاد التنوع، كلما كان من الصعب رسم صورة واحدة. لكنه، وبطبيعة الحال، ينبغي للمعايير العالمية أن تساعد هنا. هل يمكن تحقيق ذلك؟ لا شك أن الأمر صعب، وليس من السهولة بمكان القيام به، إلا أنه وأولا، لا ينبغي أن يكون هناك موقف حيث يعتبر نموذج دولة واحدة أو جزء صغير نسبيا من الإنسانية نموذجا عالميا يفرض على الجميع. وثانيا، لا يمكن قبول أي قانون تقليدي، أو حتى مطور ديمقراطيا بالكامل، ونسبه إلى الأبد كتوجيه وإملاء، كحقيقة لا جدال فيها، على الآخرين. إن المجتمع الدولي كائن حي، تكمن قيمته وتفرده في تنوعه الحضاري. والقانون الدولي هو الآخر نتاج اتفاقيات لا بين الدول، بل بين الشعوب، لأن الوعي القانوني جزء لا يتجزأ وأصيل في الثقافات والحضارات. وأزمة القانون الدولي التي يتحدث عنها الناس الآن هي، على نحو ما، أزمة نمو. فصعود الشعوب والثقافات التي ظلت في السابق، لسبب أو لآخر، على الهامش السياسي، يعني أن أفكارها الأصلية حول القانون والعدالة تلعب دورا متزايد الأهمية. هم مختلفون، وربما يعطي هذا انطباعا بوجود نوع من الخلاف والنشاز، لكن ذلك ليس سوى المرحلة الأولى من التطور. وأنا مقتنع بأن النظام الجديد ممكن فقط على مبادئ تعدد الأصوات، الصوت المتآلف لجميع الأصوات الموسيقية. فنحن، إذا شئتم، نتحرك نحو نظم عالمي لا متعدد المراكز بقدر ما هو متعدد الأصوات، بحيث يسمع كل صوت على انفراد، لكن الأهم هو سماع كل الأصوات بالتزامن في تآلف. وأولئك الذين تعودوا على العزف المنفرد، ويريدون التفرد سيكون عليهم التعود على المدونة الموسيقية الجديدة لجميع الأصوات بالتزامن. شرحت ما هو القانون الدولي بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، والذي يستند إلى ميثاق الأمم المتحدة الذي كتبته الدول المنتصرة. إلا أن العالم لم يتغير، وبطبيعة الحال، تظهر مراكز قوى جديدة، وتنمو اقتصادات قوية وتتصدر القمة، لذلك يحتاج التنظيم القانوني هو الآخر إلى التغيير، وبالطبع يجب أن يتم ذلك بعناية، لكنه أمر لا مفر منه. فالقانون هو ما يجب أن يعكس الواقع لا العكس.
- ثالثا، قلت أكثر من مرة أن العالم الجديد لا يمكن أن يتطور بنجاح إلا على مبادئ التمثيل الأقصى. وقد أظهرت تجربة العقدين الأخيرين بوضوح ما يؤدي إليه اغتصاب السلطة، ورغبة البعض في انتحال الحق في التحدث والتصرف نيابة عن الآخرين. وأولئك الذين يطلق عليهم عادة القوى العظمى، اعتادوا على الاعتقاد بأن لديهم الحق في تحديد اهتمامات الآخرين، أمر مثير حقا، أن تملي على الآخرين مصالحهم الوطنية على أساس مصالحك الخاصة. إن هذا لا ينتهك مبادئ الديمقراطية والعدالة فحسب، بل إن أسوأ ما في الأمر، أنه، في الواقع، لا يسمح لنا بحل المشكل الملحة حقا. والعالم القادم لن يكون بسيطا بسبب تنوعه على وجه التحديد، وكلما زاد عدد المشاركين الكاملين في العملية، كلما كان من الصعب بالطبع العثور على الخيارات المثلى التي تناسب الجميع. ولكن، عندما يتم العثور عليها، فهناك أمل في أن يكون الحل مستداما وطويل الأجل، وهو ما يسمح أيضا بالتخلص من الاستبداد والتذبذب المندفع، وعلى العكس من ذلك، يجعل العمليات السياسية هادفة وعقلانية ومسترشدة بمبدأ الاكتفاء العقلاني. وبشكل عام، فهذا المبدأ منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، وهو مبدأ موجود في مجلس الأمن الدولي التابع للمنظمة. ما هو حق النقض “الفيتو”، ولماذا اخترع؟ حتى لا يتم اتخاذ قرارات لا تناسب اللاعبين على الساحة الدولية. هل هو أمر جيد أم سيء؟ ربما يكون أمرا سيئا بالنسبة لأحدهم أن يضع العراقيل أمام قرارات معينة، لكنه، في الوقت نفسه، أمر جيد بمعنى أن القرارات التي لا تناسب أحد الأطراف لا يتم اتخاذها. وماذا يعني هذا؟ ما الذي يقوله هذا المعيار؟ يقول إنه يتعين الذهاب إلى غرفة الاجتماعات والتفاوض، وهذا هو بيت القصيد. ولكن مع تحول العالم إلى متعدد الأقطاب، من الضروري إيجاد الأدوات التي من شأنها توسيع نطاق استخدام آليات من هذا النوع. وفي كل حاجة محددة، لا ينبغي أن يكون القرار جماعيا فحسب، بل يجب أن يشمل كل المشاركين القادرين على تقديم مساهمة هادفة وهامة في حل المشكلات. فهؤلاء، وقبل كل شيء، هم المشاركون الذين يهتمون بشكل مباشر في إيجاد طريقة إيجابية للخروج من الوضع، لأن أمنهم في المستقبل، وبالتالي رخاؤهم، يعتمد واقعيا على ذلك. هناك أمثلة لا حصر لها على مدى تحول التناقضات المعقدة، ولكن القابلة فعليا للحل للبلدان والشعوب المجاورة إلى صراعات مزمنة لا حل لها بسبب المؤامرات والتدخل الجسيم للقوى الخارجية، والتي من حيث المبدأ، لا تهتم فيما بعد بما يحدث للمشاركين في هذه الصراعات، وكم الدماء التي سيتم سفكها، وعدد الضحايا الذين سيعانون. فالمتدخلين من الخارج ينقادون لمصالحهم الأنانية البحتة دون أن يتحملوا أي مسؤولية. أعتقد أيضا أن المنظمات الإقليمية ستلعب دورا خاصا في المستقبل، لأن الدول المتجاورة، مهما كانت العلاقات بينها صعبة، تجمعها دائما مصلحة مشتركة في الاستقرار والأمن. والحلو الوسط أمر حيوي بالنسبة لهم لتحقيق الظروف المثلى لتنميتهم.
- رابعا، المبدأ الأساسي هو الأمن للجميع بلا استثناء. ولا يمكن ضمان أمن البعض على حساب أمن الآخرين. ولا أخترع هنا شيئا جديدا، وإنما هو أمر منصوص عليه في وثائق منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، كل ما هنالك أنه يجب تنفيذه. إن نهج الكتل هو إرث الحقبة الاستعمارية للحرب الباردة، ويتعارض مع طبيعة النظام الدولي الجديد، الذي يتسم بالانفتاح والمرونة. لم يتبق في العالم اليوم سوى كتلة واحدة، ملتحمة بما يسمى “الالتزام”، والعقائد الأيديولوجية الصارمة والكليشيهات، هو حلف شمال الأطلسي “الناتو”، الذي أصبح الآن، يحاول دون توقف عند حدود شرق أوروبا، التوسع إلى مساحات أخرى من العالم، في انتهاك لوثائقه القانونية الخاصة، إنها مفارقة تاريخية صريحة. لقد تحدثنا أكثر من مرة عن الدور المدمر الذي استمر حلف “الناتو” في لعبه، لا سيما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وحلف “وارسو”، عندما بدأ الحلف في فقدان السبب والمعنى الرسمي المعلن لوجوده. ويبدو لي أن الولايات المتحدة أدركت أن هذه الأداة قد أصبحت غير جذابة وغير ضرورية، لكنها كانت بحاجة إليها وتحتاج إليها اليوم لتتولى القيادة في منطقة نفوذها. ولهذا السبب هناك حاجة للصراعات. وكما تعلمون، وحتى قبل كل الصراعات الحادة التي نشهدها اليوم، أخبرني عدد من الزعماء الأوروبيين بأنهم في الولايات المتحدة، يخيفونهم بروسيا، في الوقت الذي لا يرون في أوروبا أي تهديدات من قبل روسيا. إنه كلام مباشر، أعتقد أنهم في الولايات المتحدة فهموا ذلك جيدا، وشعروا به، وتعاملوا بالفعل مع حلف “الناتو” باعتباره منظمة ثانوية، تحافظ على قيمتها وجاذبيتها من إخافة أوروبا بشكل صحيح. ولهذا تبرز الحاجة إلى تمزيق العلاقة بين روسيا وأوروبا، وخاصة روسيا وألمانيا، وروسيا وفرنسا، من خلال الصراعات. هذا ما أدى إلى انقلاب أوكرانيا والعملية العسكرية في الجنوب الشرقي من إقليم دونباس. لقد أجبرونا ببساطة على الرد، وبهذا المعنى حققوا ما يريدون. يبدو لي أن الشيء نفسه يحدث في آسيا، وفي شبه الجزيرة الكورية. إننا نرى في الواقع أن الأقلية العالمية، من خلال الحفاظ على كتلتها العسكرية وتعزيزها، تأمل في الاحتفاظ بالسلطة بهذه الطريقة. ومع ذلك، وحتى داخل هذه الكتلة نفسها، من الممكن بالفعل أن نفهم ونرى أن الإملاءات القاسية من جانب “الأخ الأكبر” لا تساهم بأي شكل من الأشكال في حل المشكلات التي تواجه الجميع. علاوة على ذلك، فإن مثل هذه التطلعات تتعارض بشكل واضح مع مصالح بقية العالم، الذي يرى أن التعاون مع الأطراف المفيدة، وإقامة شراكات مع المهتمين هو الأولوية الواضحة لمعظم دول العالم. ومن الواضح أن الكتل العسكرية والسياسية والأيديولوجية هي نوع آخر من العراقيل التي أقيمت في طريق التطور الطبيعي لمثل هذا النظام الدولي. وفي الوقت نفسه، أشير إلى مفهوم “اللعبة الصفرية”، التي تؤدي إلى فوز طرف واحد، وخسارة البقية، وهو نتاج الفكر السياسي الغربي، وهو المفهوم الذي فُرض على الجميع باعتباره مفهوما عالميا، في فترة هيمنة الغرب، إلا أنه أبعد ما يكون عن العالمية، ولا ينجح دائما. على سبيل المثال، فإن الفلسفة الشرقية، وكثيرون هنا في هذه الغرفة يعرفون ذلك حق المعرفة، وربما أفضل مني، مبنية على نهج مختلف تماما. حيث تعتمد هذه الفلسفة على البحث عن انسجام المصالح حتى يمكن للجميع تحقيق ما هو أكثر أهمية لهم، ولكن ليس على حساب مصالح الآخرين. “أفوز أنا وتفوز أنت أيضا”. وكان الشعب الروسي وسائر الشعوب التي تعيش داخل روسيا تنطلق دائما، قدر المستطاع، من حقيقة أن الشيء الرئيسي ليس محاولة فرض الرأي بأي وسيلة وطريقة، ولكن محاولة إقناع الآخرين والاهتمام بالشراكة الصادقة والتفاعل الندي. لقد أثبت تاريخنا، بما في ذلك تاريخ الدبلوماسية الداخلية، مرارا وتكرارا ما تعنيه قيم الشرف والنبل وصنع السلام والتنازل. ويكفي أن نتذكر دور روسيا في هيكل أوروبا بعد عصر الحروب النابليونية. أعلم أنه يُنظر إلى هذا، إلى حد ما، بوصفه عودة لمحاولة الحفاظ على الملكية هناك وما إلى ذلك، لكن ما يدور الحديث عنه هنا في هذه النقطة هو النهج المتبع في كيفية حل هذه القضايا. إن النموذج الأولي للطبيعة الجديدة والحرة وغير المتكتلة للعلاقات بين الدول والشعوب هو المجتمع الذي يتم تشكيله الآن في إطار مجموعة “بريكس”. وهذا، من بين أمور أخرى، يؤكد بوضوح حقيقة أنه حتى من بين أعضاء “الناتو” هناك من يهتمون بالعمل الوثيق مع مجموعة “بريكس”، ولا أستبعد أن تفكر دول أخرى في المستقبل بالعمل المشترك الوثيق مع مجموعة “بريكس”. لقد ترأست بلادنا “بريكس” هذا العام، وقد عقدت قمة مؤخرا في قازان، ولا أخفي أن تطوير نهج منسق بين العديد من البلدان، التي لا تتطابق مصالحها دائما في كل شيء، ليس بالمهمة السهلة. وكان على الدبلوماسيين وغيرهم من المسؤولين الحكوميين بذل أقصى قدر من الجهد واللباقة وإظهار القدرة على الاستماع والإنصات لبعضهم البعض من أجل تحقيق النتيجة المرجوة. وبذل الجميع كثيرا من الجهد في ذلك. إلا أنها الطريقة التي تولد بها روح التعاون الفريدة، التي لا تقوم على الإكراه والإملاءات، وإنما على التفاهم المتبادل.ونحن على ثقة من أن مجموعة “بريكس” تقدم نموذجا جيدا للتعاون الحقيقي البناء في البيئة الدولية الجديدة. وأضيف أن منصات “بريكس” واجتماعات رجال الأعمال والعلماء والمثقفين في بلداننا يمكن أن تصبح مساحة لفهم فلسفي عميق وأساسي للعمليات الحديثة للتنمية العالمية، مع الأخذ في الاعتبار خصائص كل حضارة بثقافتها وتاريخها وقيمها وهويتها وتقاليدها. إن روح الاحترام ومراعات المصالح هي الأساس للنظام المستقبلي للأمن الأوراسي الذي بدأ يتشكل في قارتنا الضخمة، وهو ليس نهجا متعدد الأطراف بحق فحسب، وإنما هو نهج متعدد الأوجه أيضا. ففي نهاية المطاف، يشكل الأمن اليوم مفهوما معقدا لا يشمل فقط الجوانب العسكرية والسياسية، فالأمن مستحيل من دون ضمانات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وضمان استقرار الدول في مواجهة أي تحديات، تحديات الطبيعة والتحديات من صنع الإنسان، سواء كان الحديث يدور عن العالم المادي أو الرقمي أو الفضاء الإلكتروني وما إلى ذلك.
- خامسا، العدالة للجميع. فإن عدم المساواة هو الآفة الحقيقة التي يواجهها العالم الحديث. وداخل البلدان، يؤدي عدم المساواة إلى التوتر الاجتماعي وعدم الاستقرار السياسي. أما على الساحة العالمية، فإن الفجوة في مستوى التنمية بين “المليار الذهبي” وبقية البشرية محفوفة ليس فقط بالتناقضات السياسية المتزايدة، بل وأيضا بمشكلات الهجرة المتفاقمة. وتواجه جميع البلدان المتقدمة تقريبا على هذا الكوكب تدفقا غير منضبط بشكل متزايد لأولئك الذين يأملون بهذه الطريقة في تحسين وضعهم المالي ورفع وضعهم الاجتماعي والبحث عن أفق للمستقبل، وفي بعض الأحيان مجرد الهروب من أجل البقاء على قيد الحياة. في المقابل، فإن ظاهرة الهجرة تلك تؤدي إلى زيادة كراهية الأجانب والتعصب تجاه الوافدين الجدد إلى المجتمعات الأكثر ثراء، ما يؤدي إلى دوامة من سوء الحالة الاجتماعية والسياسية وزيادة مستوى العدوانية. كما ان تأخر العديد من البلدان والمجتمعات من حيث التنمية الاجتماعية والاقتصادية هو ظاهرة معقدة. وبطبيعة الحال، لا يوجد علاج سحري لهذا المرض، بل إننا بحاجة إلى عمل منهجي طويل الأجل. وفي كل الأحوال، من الضروري تهيئة الظروف التي يمكن في ظلها إزالة العقبات المصطنعة ذات الدوافع السياسية التي تعترض التنمية. ومحاولات استخدام الاقتصاد كسلاح، بغض النظر عمن يتم توجيهه ضده، تضرب الجميع بلا استثناء، لا سيما الأكثر ضعفا وهشاشة، الأشخاص والبلدان التي تحتاج إلى الدعم. ونحن على قناعة بأن مشكلات الأمن الغذائي وأمن الطاقة، والحصول على الخدمات في مجال الصحة والتعليم وأخيرا إمكانية الانتقال القانوني ودون عوائق للأشخاص ينبغي وضعها خارج أقواس أي صراعات أو تناقضات، فتلك هي حقوق الإنسان الأساسية.
- سادسا، نحن لا نكلّ أبدا من التأكيد على أن أي هيكل دولي مستدام لا يمكن أن يقوم سوى على مبادئ المساواة في السيادة. نعم، كل الدول لديها إمكانيات مختلفة، وهو أمر واضح، كذلك فإن الفرص المتاحة لها بعيدة كل البعد عن التكافؤ. ونسمع الكثير بهذا الصدد من أن المساواة الكاملة مستحيلة وطوباوية ووهمية، إلا أن خصوصية العالم الحديث، المترابط والمتكامل بشكل وثيق، تكمن على وجه التحديد في حقيقة أن الدول التي ليست الأقوى أو الأكبر، غالبا ما تلعب دورا أكبر من العمالقة، وذلك فقط لأنها قادرة على استخدام أكثر عقلانية واستهدافا لإمكانياتها البشرية والفكرية والطبيعية والبيئية، وهي أكثر قدرة في التعامل مع القضايا المعقدة بمرونة وذكاء، ووضع معايير عالية في نوعية الحياة والأخلاق وكفاءة الإدارة، وهي الدول الأقدر على خلق فرص لتحقيق الذات للجميع، ولتهيئة الظروف والمناخ النفسي المناسب في المجتمع لنهضة العلم وريادة الأعمال والفن والإبداع واكتشاف المواهب لدى الشباب. وكل تلك أصبحت اليوم من عوامل النفوذ العالمي، ولإعادة صياغة قوانين الفيزياء: فحتى لو فقدت المضمون لا زال بإمكانك الفوز في النتائج. إن الشيء الأكثر ضررا وتدميرا والذي يتجلى في عالم اليوم هو الغطرسة، والنظرة الفوقية لأحد، بل والرغبة اللانهائية في الأستاذية وإملاء الإرادة، وهو ما لم تفعله روسيا قط، وهو أمر غير معتاد بالنسبة لها. ونحن نرى أن نهجنا مثمر، وتُظهر التجربة التاريخية بما لا يدع مجالا للشك أن التفاوت بين الناس، سواء على مستوى المجتمع أو على مستوى الدولة أو على الساحة الدولية يؤدي بالضرورة إلى عواقب وخيمة. أود الإضافة هنا إلى أنه وعلى مدار عدة قرون، وهو أمر ربما لم أذكره كثيرا، طوّر العالم المتمركز حول الغرب بعض الكليشيهات والصور النمطية ونوعا من التسلسل الهرمي. ثمة عالم متقدم، وإنسانية متقدمة، ونوع من الحضارة العالمية التي يجب على الجميع أن يسعى نحوها، وهناك شعوب وحشية متخلفة وغير متحضرة، وهؤلاء يجب أن يستمعوا دون شك إلى ما يقال لهم من الخارج، والتصرف بناء على تعليمات أولئك الذين يفترض أنهم يقفون فوق هذه الشعوب في التسلسل الهرمي الحضاري. من الواضح طبعا أن مثل هذا الشعار يعود لنهج استعماري فج لاستغلال الأغلبية العالمية. إلا أن المشكلة تكمن في أن هذه الأيديولوجية العنصرية في أساسها قد ترسخت في أذهان الكثيرين، وهي عقبة عقلية خطيرة أمام التنمية العالمية المتناغمة. إن العالم الحديث لا ينبذ الغطرسة فحسب، بل ينبذ كذلك الصمم تجاه خصوصيات الآخرين، وأصالتهم. ولبناء علاقات طبيعية عليك أولا أن تستمع إلى محاولك، وأن تفهم منطقه وأساسه الثقافي، ولا تنسب إليه ما تعتقده أنت عنه. وإلا سيتحول التواصل إلى تبادل للكليشيهات وتعليق المسميات، وتتحول السياسة إلى حوار الطرشان. وكما ترون بالطبع، فإن الناس يظهرون اهتماما ببعض الثقافة الأصلية لمختلف الشعوب، ويبدو هذا ظاهريا أمر جميل، وتبدو الموسيقى والفولكلور في صعود، لكن يظل جوهر السياسات في مجالات الاقتصاد والأمن كما هو: سياسة استعمارية جديدة. انظروا إلى كيفية عمل منظمة التجارة العالمية، لا تحل أي شيء، لأن جميع الدول الغربية والاقتصادات الكبرى تمنع كل شيء، تمنع كل ما يتعارض مع مصلحتهم الخاصة، ويتم استعادة وتكرار نفس ما كان يحدث قبل عقود وقرون، لإبقاء الجميع في طابور واحد، هذا كل ما في الأمر. يجب علينا ألا ننسى أن الجميع متساوون بمعنى أن لكل طرف الحق في رؤيته الخاصة، والتي هي ليست أفضل أو أسوأ من الآخرين، هي ببساطة رؤية خاصة، يجب احترامها. وعلى هذا الأساس يتم صياغة الفهم المتبادل للمصالح والاحترام والتعاطف، أي القدرة على التعاطف والشعور بمشكلات الآخرين والقدرة على إدراك وجهة نظر شخص آخر وحججه. ولا يجب فقط إدراك ذلك، وإنما التصرف وفقا له، وبناء سياساتك الخاصة وفقا لذلك. فالإدراك لا يعني القبول والموافقة على كل شيء، هذا غير صحيح، وإنما يعني في المقام الأول الاعتراف بحق المحاور في رؤيته للعالم. في الواقع، هذه هي الخطوة الأولى الضرورية للبدء في إيجاد الانسجام بين وجهات النظر العالمية، وعلينا أن نتعلم كيف ننظر إلى الاختلاف والتنوع باعتبارهما ثروة وفرصا، وليس باعتبارهما سببا للصراع، وهذه أيضا هي جدلية التاريخ. إننا ندرك أن عصر التحولات الأساسية هو وقت الاضطرابات الحتمية، لسوء الحظ، وهو وقت تصادم المصالح، ونوع من الطحن الجديد لبعضنا البعض. لكن، وفي الوقت نفسه، فإن ترابط العالم لا يؤدي بالضرورة إلى تخفيف التناقضات، وهذا أيضا صحيح. بل، وعلى العكس من ذلك، يمكن أن يتفاقم الأمر في بعض الأحيان، ما يجعل العلاقات أكثر إرباكا، ويجعل إيجاد المخرج أكثر صعوبة. وعلى مدى قرون من التاريخ، اعتادت البشرية على حقيقة أن الطريقة النهائية لحل التناقضات هي حل الأمور باستخدام القوة. نعم، يحدث هذا أيضا، والقوة تغلب الحق. وهذا مبدأ يعمل هو الآخر. نعم، يحدث هذا في كثير من الأحيان، ويتعين على الدول أن تدافع عن مصالحها بقوة السلاح، وتدافع عنها بكل الوسائل المتاحة. لكن العالم الحديث معقد وصعب، ويزداد تعقيدا وصعوبة. وبحل مشكلة واحدة، يؤدي استخدام القوة، بطبيعة الحال، إلى خلق مشكلات أخرى، غالبا ما تكون أكثر صعوبة. ونحن نتفهم ذلك أيضا. بهذا الصدد فإن بلادنا لم تبادر قط، ولا تبادر إلى استخدام القوة. ونفعل ذلك فقط عندما يصبح من الواضح أن الخصم يتصرف بعدوانية تمنعه من قبول أي حجج على الإطلاق. وعند الضرورة فقط، نتخذ بالطبع جميع التدابير لحماية روسيا ومواطنيها وسنحقق أهدافنا دائما.
إن العالم ليس خطيا وغير متجانس داخليا على الإطلاق، وهو ما فهمناه دائما وندركه. ولا أود الخوض في الذكريات اليوم، لكني أتذكر جيدا ما واجهناه عام 1999، عندما كنت رئيسا للحكومة، وأصبحت رئيسا للدولة، وأعتقد أن المواطنين الروس، والمتخصصين الموجودين في هذه القاعة، يتذكرون جيدا أيضا القوى التي كانت تقف وراء الإرهابيين في شمال القوقاز، وأين وبأي كميات حصلوا على الأسلحة والأموال والدعم المعنوي والسياسي والأيديولوجي والمعلوماتي.
بل إنه من المضحك أن نتذكر، هو أمر حزين ومضحك في آن، كيف قالوا: هذه هي “القاعدة”، تنظيم “القاعدة” سيء بشكل عام، لكنه عندما يقاتل ضدك فلا بأس. ما هذا؟ إنه يؤدي إلى الصراع. ومن ثم وضعنا لأنفسنا هدفا باستغلال كل الوقت المتاح لدينا واستخدام كل قوتنا للحفاظ على الوطن. وبطبيعة الحال، كان هذا في مصلحة جميع شعوب روسيا. وعلى الرغم من الوضع الاقتصادي الصعب بعد أزمة 1998، والدمار الذي أصاب الجيش، يجب أن نقولها بصراحة، فنحن جميعا، كدولة بأكملها، قمنا بصد هجوم الإرهابيين، وهزمناهم.
لماذا أتذكر هذا الآن؟ لأنه، ومرة أخرى، كان لدى البعض فكرة أن العالم سيكون أفضل بدون روسيا، وحاولوا القضاء عليها، لاستكمال انهيار كل ما تبقى من انهيار الاتحاد السوفيتي. الآن، يبدو أن هناك من لا زال يحلم بذلك أيضا. ويعتقدون أن العالم سيكون أكثر طاعة وأفضل انصياعا للحكم. لكن روسيا أوقفت أولئك الذين يسعون إلى الهيمنة على العالم أكثر من مرة، بغض النظر عمن فعل ذلك. وسوف يحدث ذلك دائما، والعالم لن يتحسن طالما بقي أولئك الذين يحاولون القيام بذلك. يجب عليهم أن يفهموا في النهاية أن الأمر سيصبح أكثر صعوبة.
وجود روسيا في حد ذاته هو ضمانة لاحتفاظ العالم بتعدد ألوانه وتنوعه وتعقيده
يجد خصومنا طرقا وأدوات جديدة لمحاولة التخلص منّا. والآن يتم استخدام أوكرانيا والأوكرانيين الذين يدربونهم كأدوات خصيصا لمواجهة الروس، فيحولونهم بدلا من ذلك لعلف للمدافع. وكل هذا يرافقه حديث معسول حول الخيار الأوروبي. خيار رائع! خيار لا نحتاجه بكل تأكيد، سنحمي أنفسنا وشعبنا، ولا ينبغي لأحد أن يكون لديه أي أوهام بهذا الشأن.
لكن دور روسيا، بطبيعة الحال، لا ينتهي عند هذا الحد، بل يقتصر على الدفاع عن نفسها والحفاظ على وجودها. قد تبدو الكلمات جليلة بعض الشيء، إلا أنها حقيقة، فوجود روسيا في حد ذاته هو ضمانة لاحتفاظ العالم بتعدد ألوانه وتنوعه وتعقيده، وهذا هو مفتاح التنمية الناجحة. إنها ليست كلماتي، وإنما كلمات أصدقائنا من جميع مناطق العالم، ولا أبالغ في ذلك، وأكرر: نحن لا نفرض شيئا على أحد ولن نفعل ذلك أبدا. نحن أنفسنا لا نحتاج إليه، نحن نسترشد بقيمنا واهتماماتنا وتوقعاتنا المتجذرة في هويتنا وتاريخنا وثقافتنا. وبالطبع نحن دائما على استعداد للحوار البناء مع الجميع.
ليس من حق أي أحد يحترم ثقافته وتقاليده ألا يعامل الآخرين بنفس الاحترام. وأولئك الذين يحاولون إجبار الآخرين على التصرف بشكل غير لائق يلقون دائما بجذورهم وحضارتهم وثقافتهم في الوحل، وهو ما نلاحظه جزئيا.
إن روسيا اليوم تناضل من أجل حريتها وحقوقها وسيادتها. أقولها دون مبالغة، لأن كل شيء بدا خلال العقود الماضية مواتيا ولائقا شكليا: تحولت مجموعة الدول السبع إلى مجموعة الدول الثمانية، شكرا على الدعوة.
ابتسامة مجموعة السبع الماكرة
لكن هل تعرفون ما كان يحدث؟ رأيت بأم عيني أنه عندما تأتي إلى نفس تلك المجموعة، مجموعة الثمانية، يصبح من الواضح على الفور أنه قبل الاجتماع داخل مجموعة الدول الثمانية، كان هناك سبعة قد اجتمعوا بالفعل وناقشوا شيئا ما فيما بينهم، بما في ذلك ما يتعلق بروسيا، ثم قاموا بدعوة روسيا. فتنظر إليهم بابتسامة، كنت أفعل ذلك دائما، ثم يعانقونك بشكل جميل ويربتون على كتفك. في الممارسة العملية، يفعلون عكس كل هذا. ويستمرون في المناورة والمراوغة، وهو ما تجلى في سياق توسع حلف “الناتو” شرقا. لقد وعدوا بأنهم لن يفعلوا ذلك، لكنهم استمروا فيه. وتجلى ذلك في القوقاز، وفي نظام الدفاع الصاروخي، في كل شيء. في أي قضية رئيسية كان من الواضح أنهم لم يهتموا ببساطة برأينا. في نهاية المطاف بدا كل هذا وكأنه تدخل زاحف، والذي يهدف، دون أي مبالغة، إلى نوع من الإذلال، بل، ومحاولة لتدمير البلاد: إما من الداخل أو من الخارج.
ووصلوا أخيرا إلى أوكرانيا، ودخلوا هناك بقواعدهم العسكرية وبـ “الناتو” في 2008: اتخذ قرار في بوخارست بفتح الأبواب أمام أوكرانيا وجورجيا للانضمام إلى الحلف. ممن تخافون، وضد أي تهديدا؟ هل كانت هناك أية صعوبات، ربما في الشؤون الدولية؟ نعم، تجادلنا مع أوكرانيا بشأن أسعار الغاز، لكننا توصلنا إلى اتفاق على أية حال. فما المشكلة إذن؟ وكان من الواضح إلى ماذا سيؤدي ذلك. إلا أنهم تمادوا وتمادوا، وبدأوا في الاستيلاء على أراضينا التاريخية، ودعم النظام ذو التحيز الواضح للنازيين الجدد.
لذلك يمكننا القول وأكرر بكل ثقة: نحن نناضل ليس فقط من أجل حريتنا، وليس فقط من أجل حقوقنا، ولا فقط من أجل سيادتنا، وإنما ندافع عن الحقوق والحريات العالمية، وفرص وجود وتطور الأغلبية المطلقة من الدول. وتلك هي المهمة الملقاة على عاتقنا. وينبغي أن يكون واضحا للجميع أنه من غير المجدي ممارسة الضغط علينا، لكننا دائما على استعداد للتفاوض مع المراعاة الكاملة للمصالح المشروعة المتبادلة. لهذا أدعو جميع المشاركين في الاتصالات الدولية على القيام بذلك. ومن ثم، فليس هناك شك في أن الضيوف المستقبليين لاجتماع منتدى”فالداي”، ربما لا يزالون اليوم من أطفال المدارس أو الطلاب أو طلاب الدراسات العليا أو شباب العلماء أو الخبراء الطموحين، سيناقشون خلال عقدين من اليوم، عشية الذكرى المئوية للأمم المتحدة، قضايا أكثر تفاؤلا وتأكيدا على الحق في الحياة من تلك التي يتعين علينا أن نناقشها اليوم.
شكرا جزيلا على اهتمامكم.
المصدر: RT
إقرأ المزيد

بوتين يرسم ملامح النظام العالمي الجديد وعلاقته مع زعمائه
عرض بوتين في كلمة وحوار مطول أمام منتدى “فالداي” في سوتشي أمس رؤيته للنظام العالمي الجديد ومستقبل علاقات روسيا مع دول العالم بما فيها الولايات المتحدة، وسبل حل الملفات الساخنة.